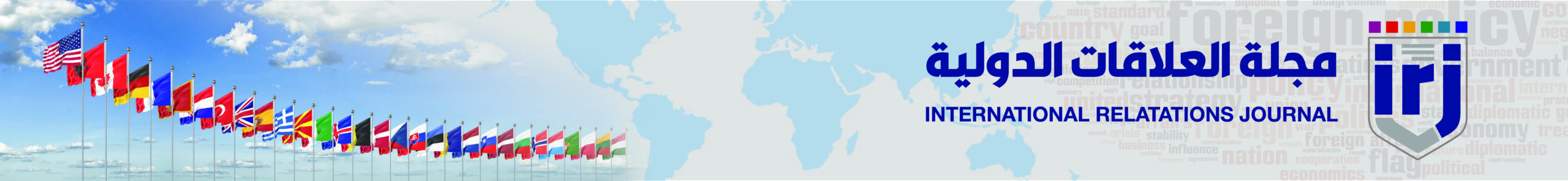صدور العدد العاشر من مجلة العلاقات الدولية (أكتوبر 2025)
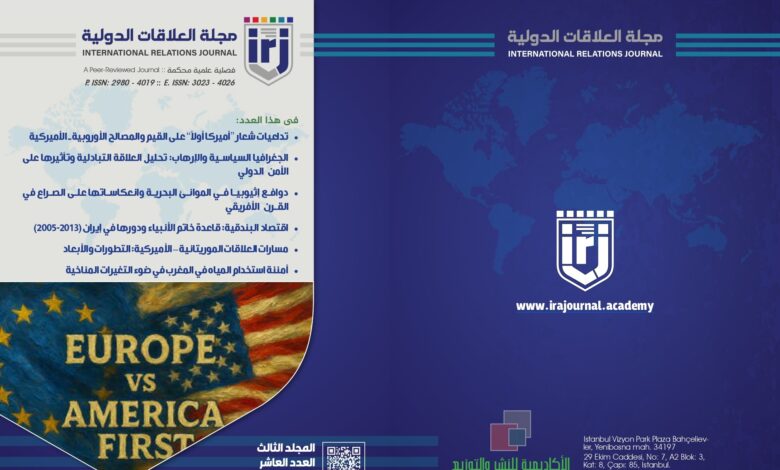
يأتي العدد العاشر من مجلة أكاديمية العلاقات الدولية، إصدار أكتوبر/ تشرين الأول 2025، في سياق عالمي يتسم بتعقد التفاعلات الجيوسياسية وزيادة التحديات الاقتصادية والأمنية والبيئية، حيث تتقاطع المصالح الاقليمية والدولية في فضاء تسوده ديناميات جديدة من التعاون والصراع.
يهدف هذا العدد للاسهام في النقاش العلمي حول أبرز القضايا الراهنة التي تمس بنية النظام الدولي، من خلال مجموعة من الدراسات الأكاديمية التي تعكس عمق التحليل وتعدد المقاربات المنهجية.
الدراسة الأولى: “الجغرافيا السياسية والإرهاب: تحليل العلاقة التبادلية وتأثيرها على الأمن الدولي”
د. ياسر الطيب (السودان)
تهدف إلى تحليل العلاقة التبادلية بين الجغرافيا السياسية والإرهاب، من خلال إبراز تأثير العوامل المكانية والبيئية على انتشار التنظيمات الإرهابية وأساليب عملها. وتوضح كيف أصبحت الجغرافيا السياسية من الحدود المفتوحة في الساحل الإفريقي إلى الطبيعة التضاريسية الوعرة في أفغانستان، والحدود الهشة في بعض مناطق الشرق الأوسط، عاملاً محدداً في تحول الإرهاب إلى ظاهرة عابرة للحدود.
كما تعتمد الدراسة على مقاربات نظرية متنوعة (واقعية، بنائية، ليبرالية، نقدية) لفهم الظاهرة بأبعادها المتعددة، مع التركيز على دورالعولمة والتكنولوجيا الرقمية في تمكين التنظيمات الإرهابية. وتخلص الورقة إلى ضرورة صياغة استراتيجيات متكاملة لمكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية تعزيزاً للأمن والاستقرار العالمي.
الدراسة الثانية: “تداعيات شعار “أميركا أولاً” على القيم والمصالح الأوروبية ــــ الأميركية”
د. جميل مطر (لبنان)
تهدف إلى تحليل انعكاسات هذا الشعار على مسار العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة، من خلال تتبع التحولات التي أصابت هذا التحالف التاريخي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتبرز كيف انتقلت العلاقة من شراكة استراتيجية متجذرة في القيم الغربية المشتركة إلى حالة من الشرخ والتباعد السياسي نتيجة تبني الولايات المتحدة سياسة أحادية تقدم مصالحها القومية على حساب التحالف الأطلسي. كما تسلط الضوء على انعكاسات هذه السياسة على الأمن الأوروبي، وعلى دور القوى الغربية في المؤسسات الدولية، خاصة مجلس الأمن، في ظل تراجع منطق التضامن الغربي التقليدي وصعود نزعات قومية أميركية جديدة غيرت طبيعة التوازن في العلاقات عبر الأطلسي.
الدراسة الثالثة: دوافع إثيوبيا في الموانئ البحرية وانعكاساتها على الصراع في القرن الأفريقي
د. جمال عبد الرحمن رستم (السودان)
وتتناول الدوافع الإثيوبية للوصول إلى الموانئ البحرية بعد أن أصبحت دولة غير ساحلية منذ استقلال ارتيريا عام 1993، وهو ما شكل أحد أبرز التحديات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا. يسعى البحث إلى تحليل الأسباب الاقتصادية والسياسية والعسكرية وراء مساعي أديس أبابا لتأمين منفذ بحري في دول الجوار، مثل جيبوتي وإرتيريا والصومال، وإبراز انعكاسات هذه الطموحات على الصراعات الإقليمية في منطقة القرن الافريقي.
تعتمد الدراسة على مناهج متعددة تشمل التحليل التاريخي والسياسي ودراسات الحالة، لفهم طبيعة التنافس الإقليمي حول الموانئ ودور القوى المحلية والدولية فيه. وتخلص إلى أن السعي الإثيوبي الدائم نحو البحر لا يقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل يمثل رهانا استراتيجياً يؤثر مباشرة في أمن واستقرار القرن الأفريقي ومستقبل علاقات دوله البينية.
الدراسة الرابعة: اقتصاد البندقية: قاعدة خاتم الأنبياء ودورها في إيران (2005-2013)
الباحثة ريتا بولس (لبنان)
ركزت على كيفية تحويل الحرس الثوري الإيراني لسياسة الخصخصة من أداة إصلاح اقتصادي إلى آلية لتنفيذ “انقلاب ناعم”، الذي أفرز دولة عميقة تهيمن على مؤسسات الدولة المدنية. حيث تعود جذور هذه الهيمنة إلى بيئة العقوبات الدولية التي دفعت النظام نحو قنوات اقتصادية غير رسمية.
ومع ذلك، مثّلت فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد (2005-2013) “العصر الذهبي” لهذا التحول، حيث أصبحت الحكومة امتداداً للمؤسسة العسكرية، وتم تحريف الخصخصة لتصبح عملية إعادة توزيع للأصول العامة. حيث استحوذت مؤسسات الدولة والواجهات شبه الحكومية على 84% من الأصول المخصخصة، بينما لم يتجاوز نصيب القطاع الخاص الحقيقي 16% . كان الحرس الثوري، من خلال ذراعه الاقتصادي “قاعدة خاتم الأنبياء”، المستفيد الأكبر من هذه العملية، حيث احتكر مشاريع استراتجية في مجالات النفط والبنية التحتية دون منافسة.
اعتمد هذا التمكين على ثلاثة محاور متكاملة: غطاء قانوني عبر إعادة تفسير المادة (44) من الدستور، تحالف سياسي مع حكومة أحمدي نجاد، توظيف أيديولوجي لمفاهيم مثل “اقتصاد المقاومة” و”الجهاد الاقتصادي” لشرعنة السيطرة. تخلص الدراسة إلى أن هذه السياسات أدت إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الإيراني بما يخدم النخب العسكرية–الدينة، وإلى تآكل الدولة المدنية لصالح دولة أمنية-عسكرية تسيطر على الثروة والقرار السياسي في إيران.
الدراسة الخامسة: مسارات العلاقات الموريتانية – الأميركية: التطورات والأبعاد
د. بتار ولد أسلك (موريتانيا)
تسلط الدراسة الضوء على التطور التاريخي للعلاقات بين موريتانيا والولايات المتحدة الأميركية منذ انطلاقتها في ستينيات القرن العشرين، مع التركيز على فترات الصعود والهبوط التي تميزت بها على مدار العقود الماضية. تقوم الدراسة بتحليل أسباب التذبذب في هذه العلاقة، مستعرضة التحولات الجوهرية التي شهدتها في المراحل اللاحقة خلال السبعينيات والثمانينيات، والتي جاءت متأثرة بظروف إقليمية ودولية متغيرة.
كما تتناول الدراسة أيضاً المراحل الأساسية التي مرت بها العلاقات بين موريتانيا والولايات المتحدة الأميركية، والتي تأثرت بدورها بالتقلبات السياسية الداخلية في موريتانيا، والفترات الانتقالية التي شهدتها البلاد بما في ذلك الانقلابات العسكرية، وصولًا إلى التطورات الحديثة.
كما تركز الدراسة على الأبعاد الأمنية والاقتصادية التي شكلت عوامل رئيسية في توجيه مسار التعاون بين الطرفين في العقدين الأخيرين مع إبراز تأثيرات القمة الافريقية الأميركية المصغرة 2025 التي كانت موريتانيا من ضمن الدول الإفريقية الخمس المدعوة لحضورها والتي مثلت نتائجها نقطة تحول مهمة في مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي.
الدراسة السادسة: أمننة استخدام المياه في المغرب في ضوء التغيرات المناخية
د. حميد ملاح (المغرب)
انطلقت الدراسة من أن المعضلة المائية العالمية تمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في القرن الحادي والعشرين، وأن المغرب يواجه ضغوطا متزايدة على موارده المائية بسبب تغير المناخ، توالي موجات الجفاف، التصحرـ تراكم الطمي في السدود، التلوث، والنمو السكاني المتسارع.
ورغم اتباع المغرب سياسة مائية استباقية قائمة على التخطيط الطويل المدى وبناء المنشآت الكبرى لتخزين المياه، إلا أن حدة الأزمة دفعت نحو أمننة قضية ندرة المياه، أي تحويلها من مسألة انسانية وتنموية إلى قضية أمنية ووجودية تستدعي تعبئة وطنية شاملة وتدابير استثنائية لضمان الأمن المائي المستدام وحماية الدولة والمجتمع من تداعياتها المستقبلية.