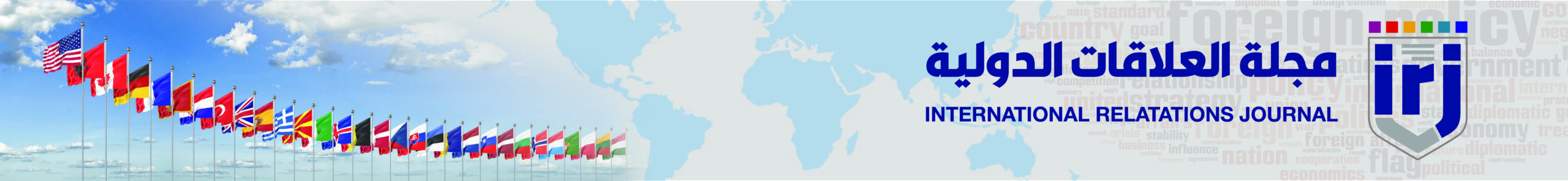سلطة الصورة في وسائل الإعلام: مداخل تأسيسية

ازدادت أهمية الصورة في الزمن المعاصر، وبدأت تتبوأ مكانة رفيعة، وتستقل تدريجيا بذاتها وتنفرد بمعجمها الخاص، وتؤسس لغتها الخاصة بمعزل عن الخطاب. ومن شأن هذا التحول الهائل أن يطرح مشكلات فلسفية عميقة حول وضعها ومكانتها في الثقافة المعاصرة. إن الصورة تمثل لوحدها مشكلة فلسفية نظرا للتغيرات العميقة التي أحدثتها في تشكيل وتكييف ما هو بصري بصفة عامة.
وصار من الضروري إعادة النظر في الأدوات الفكرية والمنهجية من أجل تأسيس مقاربة فلسفية جديدة للغة البصرية، ووجب استئناف النظر في كثير من المقولات الفكرية والجمالية من أجل فك خلفيات وأبعاد الصورة بفضل الطفرات التكنولوجية والرقمية.
فقد انتقلت الصورة من طور كانت فيه ذهنية إلى طور صارت فيه بصرية، بمعنى انها بعدما كانت في خدمت غايات روحية أصبحت تحيل إلى ذاتها. إنها استحالت إلى وسيط، مما يشرع الباب على مصراعيه على رهانات متعددة.
إن الصورة منذ ما قبل التاريخ انتقلت فيه من تبخيس “أفلاطون” لها لكونها ظلا وشبحا وضعفا إلى العصر التكنولوجي الذي حررها من التبعية، ومكنها من الخروج من التكرار إلى الابتكار. من إدانة “أفلاطون” للصورة إلى الثورة البصرية التي يشهدها الزمن المعاصر، مآل عجيب للصورة. ولكن ينبغي أن نفهم لماذا هذه الإدانة؟ لأنها في رأيه تفتح الباب على مصراعيه للشبيه والنظير، وللظلال والأشباه، ومن ثم تطلب الأمر مقاومة غموضها وإبهامها بوضوح الفكرة وسطوعها. يقول “فرانسوا داجونييه”: “يمكن اعتبار الصورة خطيرة ليس لأنها محيرة … ولكن لكونها تنفلت منا وتضعفنا، دون أن ننسى أنها تعرينا”[1].
إن للصورة ماضيا سحريا أوكل إليها وظيفة مقاومة الموت والتلاشي. بقدر ما كانت مثيرة للخوف والرعب، نقاوم بها المرعب والمخيف أي الموت، وبواسطتها يستدعى الآباء والأجداد الموتى. إن قهر الموت والتلاشي بواسطة استدعاء الصورة تلك هي المهمة الموكولة للصورة. شكل الموت التحدي الأكبر للإنسان مما استدعى الصورة من أجل البقاء والحضور: “نقاوم التلاشي المصاحب للموت بإعادة الترميم الملازم للصورة”[2].
الصورة الآلية:
يمكن أن نزعم أن الصورة تطورت عبر ثلاث لحظات أساسية، لحظة العبادة والتبجيل نظرا لوظيفتها في مقاومة الموت والتلاشي، ولحظة الإدانة الأفلاطونية لها باعتبارها تنتمي إلى عالم الأشباه، ولحظة تبوئها مكانة رفيعة في عالم الإعلام والاتصال، خاصة بعد أن حررت التكنولوجيا المعاصرة الصورة من سلبياتها، فلم تعد نسخا وإنما صارت توازي ما ينتج الشيء المنسوخ.
تعتبر الصورة الوسيط الأكثر قوة وشيوعا في العالم المعاصر نظرا لما تتيحه من إمكانيات لا متناهية للتواصل والدعاية، ومن وسائل لا محدودة للتأثير في الرأي العام، خاصة لما تحقق لها من طفرات تكنولوجية وعلى رأسها الطفرة الرقمية.
وقد حازت الصورة التكنولوجية والصناعية على اهتمام وسائل الإعلام والاتصال نظرا لسرعة تداولها وقوة تأثيرها. وظلت الصورة تمحو الحدود وتردم الهوة بين الثقافة العالمة والثقافة الجماهيرية، بين نخبة الجماهير العريضة، عندما حطمت الهرمية الثقافية والتراتبية الاجتماعية، إلى حد أنها بدت وكأنها الوسيلة التي لا غنى عنها لتحقيق المساواة بين الناس، ولجعل الثقافة والمعلومة أعدل توزيعا وأسهل ولوجا من طرف أعرض الشرائح الاجتماعية التي تعاني من الأمية التي فرضتها ولا تزال تفرضها الثقافة المكتوبة أو ما يمكن تسميته ثقافة الحرف.
غير أن الصورة المصنوعة أو المركبة أو القابلة للتركيب بكيفية تكنولوجية هي التي صارت لها القوة والهيمنة على وسائط الإعلام المعاصرة، مما يطرح السؤال عن مكوناتها وأنظمة إنتاجها التي تجعلها تحوز على هذا القدر من التأثير في العالم المعاصر، وهو ما من شأته أن يلقي بعض الضوء على رهاناتها الإيديولوجية والسياسية والمعرفية، وما يتنازع موضوعها من اتجاهات دعائية إعلامية وفنية وإخبارية أو تضليلية.
وتتعدد أنظمة الصورة بتعدد وظائفها ومهامها، وبتعدد أنواعها، ولكن يمكن القول إنها تلتقي في كونها مصنوعة وآلية وتكنولوجية، لم تعد الصورة سوى منتجا للآلة أو الأجهزة الآلية، ولم تعد موكولة لا ليد الإنسان ولا لجوارحه وإنما للوسائط الآلية التي حققتها الطفرات التكنولوجية المتعاقبة والمتلاحقة، فحلت محل العين البشرية الكاميرات والعدسات أو ما يمكن إدراجه تحت مسمى الآلات البصرية، وحلت الصور في إطار جديد هو الشاشة Ecran مثل شاشة التليفزيون وشاشة السينما وشاشة الحاسوب إلى حد تسمية المجتمعات المعاصرة مجتمعات الشاشة. إن نظام الصورة من التقطها وتركيبها إلى بثها نظام صناعي وآلي وتكنولوجي، يضمن أن تكون مباشرة وآنية وفي الزمن الواقعي، مما سيظهر جليا مع الصورة التليفزيونية والرقمية.
الصورة والرغبة:
وفي هذا الصدد تطرح علاقة الصورة بالرغبة. بحيث تستثمر في الصورة الإشهارية وسائل لإثارة الرغبة الدفينة والبدائية في الإنسان مثلما يعلمنا التحليل النفسي. إذا كان هم الإشهار هو جعل الأشياء مشتهاة أو مرغوب فيها، فإنه أقرب إلى توظيف إثارة الرغبة في سبيل ترويجها بما يضمن انحياز المشاهد لها دون أن يفطن إلى ذلك ودون أن يستشعره. فهي (الصورة الإشهارية) تعزف على أوتار حساسة إذا جاز القول، وتلعب على غرائز مخصوصة كالغرائز الجنسية والغرائز النرجسية، وغرائز الانتماء، وغرائز كالتلدد برؤية الآخرين، والتلصص عليهم، وهو ما أصبح شائعا في مجتمعات الاتصال.
وللإشارة ثمة ثلاثة أنواع من الرغبات: الرغبات النرجسية المتعلقة بالتمثل الذاتي، والرغبات الجماعية، والرغبات المتعلقة بالانتماء إلى جماعة معينة. توجه صور معينة لكل نوع من هذه الرغبات. تقدم للمنتج صورة توهم بأنه يشبع رغبة في امتلاكه، أو يسعف ممتلكه في إغوائه موضوع آخر لهذه الرغبة. وتبنى صورة مخصوصة لإرضاء الرغبات النرجسية المتعلقة بصورة الأنا، فتجعل صورة المنتج تمثل المشاهد لذاته إيجابية أمام الآخرين. تقدم لرغبات الانتماء صور إشهارية عديدة من أجل إرضاء الميل الغريزي لدى الإنسان للحماية، مثل أن يمارس رياضة جماعية أو يسافر سفرا جماعيا إلخ. لا يقدم موضوع الرغبة في الصورة الإشهارية عاريا بل مقنعا، إما باستبدال صورة الموضوع بأخرى، أو بالإشارة إلى جزء من صورته[3].
ويمكن القول عموما أن المجتمعات المعاصرة أو مجتمعات الشاشة، تنمي لدى الأفراد رغبات من نوع آخر من مثل رغبة التلصص أو التلذذ برؤية الآخرين Voyeurisme. وتستوحي الوصلات الإشهارية جانبا مهما من هذه الرغبات، محاولة إرضاءها وإشباعها بإنتاج صور تتسلل إلى الحياة الخاصة للناس والمشاهير خاصة، فتفشي ما تخفي وتظهر ما استتر، وتظهر هذه الخاصية الاستعراضية في الثقافة البصرية المعاصرة. ولاشك أن لفظ Paparazzi يشير إلى هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمعات المعاصرة، والمتمثلة في سرقة صور خاصة للمشاهير، ولعلها وجه من أوجه هذه السمات العامة التي تتسم بها مجتمعات الاتصال، والتي يمكن تلخيصها في الاتجاه العام نحو استعراض كل شيء مهما كان خاصا في الساحة العامة.
شكلت الصورة دوما مدار اهتمامات الإنسان، بفضلها يتخيل ويتصور ويتمثل، وعبرها يبني ويعيد بناء العالم وذاته، وبواسطتها يؤنسن الطبيعة الخارجية وطبيعته الداخلية، لا يحلم بعوامل أخرى مثلما لا يبنى أوهامه واستيهاماته بدونها، بل لا يبدع فنا ولا ينظم شعرا من دونها. تمثل الصورة في الثقافة المعاصرة حضورا دائما وشبه كلي، ما من مجال وما من ميدان يخلو منها، إلى حد أن هذه الثقافة صارت برمتها بصرية، أو لا غنى فيها عن الرؤية أو البصر.
رهانات الصورة بين الدعاية والإيديولوجية والسياسة:
للصورة أدوات ووظائف منها الدعائية والإيديولوجية والسياسية. يمكن أن تبدأ الصورة الورقية من الملصق الإعلاني الرامي إلى تبليغ المعلومة إلى الملصق الإشهاري الرامي إلى الترويح التجاري، إلى البلاغ السياسي الهادف إلى حشد الأتباع وإغراء المترددين. ونفس الأمر ينطبق على الصورة الرقمية أو المبثوثة على شاشة التليفزيون وعلى شبكة الإنترنيت أو على شاشات العرض الكبرى في الساحات العامة، فهي تضطلع بأدوار ووظائف منها الدعاية والإشهار، ومنها الترويج والتسويق، ومنها صناعة الرأي وتشكيل الذوق وتكييفه، وكل هذه الوظائف تنضوي تحت عنوان واحد، إذا ما جارينا مدرسة فرانكفورت: إيديولوجية الترفيه L’idéologie du divertissement. إن الترفيه لهو من وظائف الصورة المعاصرة، خاصة بعد بروز المجتمعات الاستهلاكية وظهور الصناعة الثقافية التي خصصت لها مدرسة فرانكفورت حيزا هاما من انشغالاتها. تفرض الصور في العالم المعاصر نفسها علينا بطريقة لا يمكن مقاومتها، وتمارس علينا قوة وإغراء، ويتوسل بها لترويج السلع الثقافية وتسويقها. وتمطرنا بالصور من كل حدب وصوب، تارة لطيفة وتارة عنيفة. وعندما تنتج صورا تتصف بالعنف إلى حد ما فهي تتوخى من ذلك إبهارنا بكافة الوسائل، بل وفي بعض الأحيان خداعنا، بواسطة تركيبها تركيبا يسمح ببناء عوالم افتراضية غريبة علينا ومحاولة سبر أغوارها.
ويمكن الحديث في العالم التكنولوجي المعاصر عن التداعي الحر للصور بدل الأفكار، فثمة طوفان بصري يغمر الناظر أو المشاهد، لا يترك له فرصة التقاط أنفاسه، ويصيب فكرة بالخمول، فكلما تعرض لهذا السيل الغزير من الصور، بدءا من شاشته الصغيرة وحاسوبه الشخصي إلى الملصق الإشهاري والإعلان الدعائي ازدادت سلبية حسه النقدي، وازدادت تبعيته للصور النمطية.
كما أن الحديث في هذا الصدد عن عنف ملازم للصورة، لأنها صادمة وتفرض قوتها على الناظر أو المشاهد. وهي من ثم تشل مقاومتنا، وتضرب في المنطقة الخالية من العقل، وتتجه في كثير من الأحيان إلى لاوعي المشاهد. هذا يحيلنا إلى إشكالية أخرى والتي تتمثل في ارتباط الصورة شبه العضوي بالنماذج البدائية [4]Archaïsmes.
الصورة والسلطة:
للصورة سلطة محورية في العالم المعاصر، فما هي تجليات هذه السلطة؟
تستمد الصورة سلطانها مما نستثمر فيها من رغبات، وتقوم مقام رغباتنا في تحويل العالم. إن للصورة قوة تأثير تفوق كل التوقعات في متخيل المشاهد ويكمن اختزاله في العوامل التالية:
قدرة الصورة على إقحام المشاهد في عوالم جديدة يكون مطالبا باستكشافها ومن ثم الوقوع في أسرها.
قدرة الصورة على احتواء المشاهد الذي تحدوه رغبة عارمة في أن يكون داخلها سواء تعلق الأمر بشاشة التليفزيون أو شاشة الحاسوب، معتقدا بأن الصورة تمثل الواقع.
قدرة الصورة على إقحام المشاهدين في خبرة مشتركة فلا يرون إلا ما يراه الآخرون، ومن هنا قوتها على شحن المتخيل الجمعي.
ولقد أحدثت الصورة الآلة ارتجاجا في النظام البصري المعاصر كما يقول “رجيس دوبري”، وغيرت كيفية إدراكنا للعالم. والمقصود هنا بالذات الصورة لما صارت صناعية أو تكنولوجية، سواء فوتوغرافية أو سينمائية أو تليفزيونية، مع هذا الفارق هو أن الأولى ثابتة والثانية متحركة والثالثة آنية ومباشرة.
وبالتالي فإن الصورة الصناعية أو التكنولوجية اختلفت عن سابقتها اليدوية في فرق أساسي ألا وهو استعمال النور الصناعي أو قوة الضوء الفيزيائي. لقد بدأ المصور منذ الآن يستعين بالكتابة بالنور عوض الرسم بالألوان لدى الرسام. إن لحظة اكتشاف الصورة الصناعية والتكنولوجية يعد بمثابة انعطاف هائل: “حل النور محل يد الفنان”.
وفي معرض مقارنة لثورة الطباعة بثورة الصورة يقول “دوبري”: “بتطويركم لعبارة “لكل إنسان توراته”، تحصلون على عبارة: “كل الناس قساوسة” الإصلاح، وتحصلون بالنهاية على الاقتراع العام. وبتطويركم لعبارة “لكل إنسان صورته الفتوغرافية” تحصلون على السياحة الكونية، وعلى ألبوم العائلة. لقد كانت تمثل شركة (كوداك) بالنسبة إلى الصورة ما كان يمثل “مارتن لوثر” بالنسبة للحرف”.
وقد أحدث ظهور الطباعة في القرن الخامس عشر ثورة هائلة أنهت احتكار الكنيسة للكتاب المقدس، ومكنت كل إنسان من أن يمتلك توراته الخاصة، وأشرعت الباب على مصراعيه أمام الإصلاح الديني الذي أفضى في العصور الحديثة إلى الاقتراع العام وإلى الديمقراطية. أما ظهور الآلات البصرية في منتصف القرن التاسع عشر، وتحديدا الآلة الفوتوغرافية، فقد مكن كل فرد من أن يمتلك صوره الشخصية وفضائه الخاص وألبومه العائلي وتحققت الطفرة النوعية من الحرف المطبوع إلى الصورة البصرية. إن الحاصل من هذه الثورة التكنولوجية الهائلة هو أنها عممت الصورة على نطاق واسع، مما أفسح المجال أمام ديمقراطية جديدة، هي بالذات ديمقراطية الصورة. أسهمت الصورة الفوتوغرافية في إزاحة السحر عن العالم، وعن المتاحف والكاتدرائيات، ولكن لتعود إلى إضفاء السحر على المشاهير والنجوم. انتقلت الصورة من أيقونة في سابق عهدها، إلى إشارة ضوئية في الأزمنة المعاصرة. فضلا عن ذلك أقحمتنا الصورة التكنولوجية في “الوقتي” وفي “الزمني” وفي “الحاضر”.
أي علاقة بين الصورة والسلطة؟
نجد هذا السؤال يتردد في سياقات مختلفة، وفي مناسبات متعددة بصيغة: ما الأسباب التي تمكن وسائل الاتصال الحديثة، والوسائط الجديدة من بسط سيطرتها، وتكريس سلطتها على الفضاء العام والخاص؟
هناك ثلاثة أسباب يمكن التطرق إليها:
1- إن العصر الحديث يخضع برمته للنظام البصري، ف”الكائن” برمته إذا جاز لنا استعارة عبارة “هيدجر” مشروط بثقافة وتكنولوجية وماهية الاتصال.
2- إن ممارسة السلطة تمر عبر ضبط وسائل السلطة، وعلى رأسها وسائل الإعلام والاتصال التي تملك قدرة هائلة على الذيوع والانتشار، فبواسطتها تصنع النجوم، وبفضلها يصنع المشاهير في السينما والغناء والحياة العامة والسياسة.
3- قدرة الوسائط الجديدة على صناعة الرأي العام من خلال منتديات الحوار، وشبكات التواصل الاجتماعي، بل على تعبئة الرأي العام وتحريكه.
ونظرا لأهمية الامر فبدل أن تصنع الصورة الحدث صارت هي نفسها الحدث، وفي كثير من الأحيان تحول الحدث المبتذل إلى حدث جلل، وتضمن للمشاهير كما للمغمورين قدرا زائدا من الظهور. وبالتالي أصبح الإنسان المعاصر لا يملك القوة للوقوف أمام الطوفان البصري وأمام الآلة الإعلامية. وامتلكت الصورة قوة وجبروتا بوأها مكانا هاما. إنها تؤسس لسلطة من نوع آخر، سلطة الوسيط الأكثر رواجا واستهلاكا من طرف الجميع، فقد كانت في غابر الأزمان وسيلة الإنسان إلى استمداد أسباب القوة من القوى اللامرئية، وإلى مقاومة الزوال والتلاشي، وإلى التواصل مع العالم الأخروي، أما اليوم فهي نفسها تمثل أسباب القوة.
وللحديث عن الصورة السينمائية في مطلع القرن العشرين، فقد كان حالها أكثر جاذبية، لأن هذا الاختراع البصري سحر الألباب، وجذب الغالبية من المشاهدين، الذين يمكن أن نطلق عليهم منذ الآن اسم الجماهير. إن الصورة السينمائية والفن السينمائي هما سمة القرن العشرين. أما منتصف القرن العشرين فسجل ظهور نظام آخر من الصورة، إنها الصورة التليفزيونية، وخاصة الصورة الملونة.
وللإشارة لا يرى “دوبري” أن أنظمة الصورة ليست سوى تعديل السابق للاحق، فليست الصورة السينمائية إضافة للحركة على الصورة الفوتوغرافية، ولا الصورة التليفزيونية إضفاء للمباشرة على الصورة السينمائية، ولا الصورة الفيديو اللامادية هي استعاضة واستغناء عن الصورة السينمائية المادية واكتفاء بالإشارات الكهربائية. ومن وجهة النظر التقنية كل صورة تلغي سابقتها، فلا ندرك الماضي سوى بأعين الحاضر. فالأمر لا يتعلق بتعاقب أو بتتال بقدر ما أنه يتعلق بتحول في المجال الإدراكي، فكل تقنية جديدة للصورة تترتب عنها كيفية جديدة لإدراك العالم، وما تتيحه صورة الفيديو من سرعة ومن بث مباشر يسمح بطي الزمان وباختصار المسافات والأمكنة، وباتصال مباشر بين البث والتلقي في اللحظة نفسها وفي الآن ذاته، كل هذا يجعلنا ندرك العالم على نحو مغاير لما كان عليه الأمر في زمن الصورة السينمائية المسجلة.
يقول “دوبري”: “إن في القدرة على البث الآني اختصار المسافات، وبالتالي سيطرة لوجستية العالم المرئي على لوجستية العالم المعيش”. كل شيء يتم في الآن والأوان، لا مجال للمسجل ولا للمؤجل، كل شيء مباشر، والنقل يتم في زمن البث مما أضفى على الصورة التليفزيونية، ومن بعدها صورة الفيديو قوة قاهرة وحاضرة حضورا تاما وكليا، إلى حد أنه يمكن الحديث عن توتاليتارية بصرية.
كلما تحدثنا عن الصورة غالبا ما تقترن بالإشهار بشكل عفوي، حتى أنه يمكننا اعتبارها سند أساسي له، وفي كثير من الأحيان يرتبط الإشهار بالإعلان المصور. ويمكن القول إن الإشهار مكون أساسي لثقافة الجموع أو الجمهور، وهو بصفة عامة مكون أساسي لثقافة الاستهلاك والترفيه في المجتمعات المعاصرة. فالإشهار يتوسل بالصورة البصرية أكثر من أي شيء آخر، على شكل وصلة تليفزيونية أو إعلان صحفي أو ملصق مصور، والجامع بينها هاته الصورة الآلية. وبالتالي إذا حاولنا مقاربة دور ووظيفة الصورة في الإشهار وجدنا أنها محورية، لأن لغة الإشهار غير لفظية وإنما بالأحرى بصرية.
ولمقاربة الصورة والإشهار أمامنا مدخلان: أولا التحليل السيميولوجي لكيفية اشتغالهما، وثانيا النقد الثقافي لأبعادهما. وهنا يمكننا الحديث عن فلسفة الاتصال، التي تعتمد بالأساس على معرفة سمات وخصائص لغة الإشهار، وإذا بدأنا باستكشاف بعض سمات الصور الإشهارية وجدنا أنها تعتمد على التكرار والإطناب من جهة، وعلى الجذب والإغواء من جهة أخرى. فهي تحث المرسل إليه على الإقبال على المنتج، بل وتستدعيه في لغة الإشهار البصرية، الاستعارة التي تسحب بمقتضاها خاصية السلعة على شخص أو على شيء، أو المجاز الذي يكون فيه جزء من المنتج حاملا لهذه الخاصية، وفي كلتا الحالتين لا يتوخى الإشهار الإقناع بقدر ما يهدف إلى الاستمالة.
تطرق الفلاسفة وبعض علماء الاجتماع بالنقد للإشهار وللصناعة الإشهارية. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر “ثيودور أدورنو” ومدرسة فرانكفورت، وبودريال ومدرسة علم الاجتماع النقدي.
يبدو أن نقد الإشهار يندرج ضمن نقد ثقافة الترفيه وصناعة التسلية وأوقات الفراغ في المجتمعات المعاصرة، ولكن ليس باسم أو تحت عنوان عودة أو حنين إلى الماضي، وإنما في سبيل تقويض الأوهام التي يحفل بها العالم المعاصر. يقرن بعض المحللين والنقاد الإشهار بالعصر الحديث الذي يعتبر الفراغ وضياع المعنى من أهم سماته. فهو يؤسس لعصر تسوده القيم التبادلية، ويهيمن عليه الولع بالأشياء وعبادة السلع والبضائع.
وفي أغلب الأحيان تنم لغة الإشهار على نوع من المفارقة التي تساهم في إنشاء ثقافة فاقدة للمعنى من مثل: “رونو: فاركبو السيارة التي تسبق ظلها” أو من مثل “انظر فليس ثمة ما يمكن رؤيته”. فالإشهار هو الغاية والوسيلة، الوسيط والرسالة، ومن الخطأ في أنظار هؤلاء اعتبار الإشهار مجرد تقنية للتسويق، إنه أكثر من ذلك ثقافة تكرس التبسيط والتفاهة واللامعنى.
يقول “ليبوفتسكي Gilles Lipovetsky في كتابه (عصر الفراغ L’ère du vide): “إن الإشهار لا يحكي شيئا، ويسطح المعنى”. يفضي الإشهار إلى سيادة منطق الفراغ وضياع المعنى، إنه يمثل حسب “بودريال” درجة الصفر في المعنى لأنه بلا عمق ومآله النسيان، ويمثل خطرا داهما لأنه يمتص كل أشكال التعبير الأخرى. فالثقافة المعاصرة في مجملها إشهار، نظرا لكونهما تتضمن كل أشكال التعبير التي تتجه إلى التبسيط وإلى الإغواء.
ولا شك أن المجتمعات المعاصرة تعتمد على نمط الإنتاج الإشهاري الذي يدور حول السلعة والعلامة أو “الماركة La marque”. إن الإشهار هو الرابط أو هو الوسيط الترويجي أو التسويقي الذي تلتقي فيه كل الخطابات. إن الإشهار هو اللغة المبسطة إلى الحد الأدنى. وجد الإشهار ضالته في وسائل الإعلام والاتصال الحديثة خاصة في اللغة الجديدة المتمثلة في النظام المعلوماتي، وفي أشكالها المختلفة مثل الشريط المصور. وجدير بالذكر أن الإشهار يتكون من مجموع الشعارات الداعية إلى الإقبال على استهلاك السلع. استحالت الصورة الإشهارية إلى رسالة وإلى وسيط في نفس الآن، مما يدل على أن الإشهار ليس إشهار لسلعة فحسب، وإنما إشهار لذاته، أو إشهار للإشهار. الإشهار هو العلامة الأخيرة على الفراغ والخواء في المجتمعات المعاصرة. تعتبر هذه من أهم الخلاصات التي ينتهي إليها “جان بودريال”.
أما في معرض انتقاد “ماك لوهان” للإشهار فهو يعتبره، فضلا عن فجاجته ونزعته الميالة إلى التبسيط، أداة للتنميط التي لا تهدف إلى مخاطبة الإنسان بوصفه شخصا، وإنما تروم إدماجه في الأيقونة الجماعية.
ولكن موضوعية “ماك لوهان” اقتضت منه الاعتراف بالإشهار كآلة جبارة، وجهاز اقتصادي ضخم تفوق ميزانيته في أغلب الأحيان ميزانية وزارات بأسرها مثلما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.
الإشهار وأفول المعنى:
الاشهار بمثابة مهرجان أو سيرك، بحيث أنه لا يقول شيئا ذي معنى، قوامه المبالغة وعماده اللعب على حبال العبث واللامعنى، وأساسه الفراغ، ولكن تحكمه، فيما وراء المظاهر، عقلية الحساب والتدبير والتسويق. وخلافا للاعتقاد الشائع ليس الإشهار تقنية تسويق أو وسيلة تجارية فحسب، وإنما هو شرط وجود الإنسان المعاصر الذي يتجه أكثر إلى أن يكون وجودا استعراضيا، والذي لا يهم فيه ما يحمل من معنى، وما يمثل قيمة. إنه وجود يسوده ويهيمن عليه كوجيطو السلعة على حد تعبير “جيل دولوز”. إذا ما حاولنا فهم لماذا تؤول الصورة الإشهارية إلى درجة الصفر في المعنى حسب “بودريال”، لاحظنا أن في عالم الاتصال يتقلص المعنى إلى الحدود الدنيا لصالح المعلومة. لا يهم في الإخبار والإعلام استشفاف المعنى وإنما الهام تبادل المعلومات.
وبالتالي لا يمكن مساءلة الصورة دون إدراجها في عالم الاتصال. يقابل “بودريال” بين المعنى ووسائل الاتصال، ويعتبر عالم الاتصال معني بالإعلام وبالمعلومة وغير عابئ بالدلالة أو بالمعنى. بقدر ما تزداد الرسائل التي تمطرنا بها وسائل الاتصال والإعلام تفقد معناها، فضياع المعنى ملازم لازدياد المعلومة، لأن النظام الإعلامي في صميمه وفي عمقه محطم للمعنى ويستجيب أكثر للمقتضيات الاستعمال الأداتي. يقول “بودريال” : “إن الإعلام يلتهم مضامينه ذاتها. إنه يبتلع التواصل ويبتلع ما هو اجتماعي”[5]. إن الأمر يتعلق بالإعلام الذي عوض أن ينتج المعنى، وأن يحقق التواصل يستنفذ نفسه ويستهلكها في مسرحية ما يشبه التواصل. إننا حسب أطروحة “بودريال” في عالم مليء بالأشباه والضلال Simulacres، وعوض التواصل لا يعمل عالم الاتصال سوى على الظهور بمظهر التواصل. ويقابل “بودريال” في نفس المقام الواقع بما فوق الواقع، فعالم الاتصال لا يلامس الواقع بقدر ما يلامس شبه الواقع، أو ما فوق الواقع. إن وسائل الإعلام في نظره لا تبني الأوصال الاجتماعية بقدر ما تقوم بهدمها، ومن الخطأ الاعتقاد بأننا كلما ارتبطنا بوسائل الاتصال زادت علاقتنا الاجتماعية، بل بالعكس كلما ارتبطنا بالهاتف المحمول وبالإنترنيت زادت عزلتنا.
الصورة والعنف:
عندما نحلل الصورة نجد أنها تحتوي في ثناياها، خصوصا في عالمنا المعاصر، على بذور العنف. إن استعمال صور العنف يظهر بما لا يدع مجالا للشك العنف المؤسس للصور. وعليه فصناعة الترفيه اقتضت، من أجل استهلاك مزيد من الصور، مزيدا من استهلاك العنف. وبخلاف المعتاد مما درجنا عليه من أن السينما تستحوذ على النصيب الأوفر من العنف، نلاحظ أن كل وسائل الاتصال الحديثة، من التليفزيون إلى الصحافة المكتوبة والمصورة، مرورا بالبرامج الإخبارية، والفيديوهات المبثوثة على اليوتيوب، وصولا إلى الأفلام، كلها تقدم جرعات متفاوتة المقادير من العنف.
لذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل العنف هو خاصية المجتمعات المعاصرة، وهل هو لصيق بوسائل الاتصال الحديثة؟ يمكن القول إنه لا يخلو مجتمع من المجتمعات في أي حقبة من حقب التاريخ من العنف، لكن جوهر الاختلاف هو أنه صار للعنف حظوة في مجتمعات الاتصال المعاصرة لأنه تحول إلى فرجة، وصار ملازما للشاشة، وأقرب إلى الاستعراض البصري، والظهور المرئي من أي حقبة أخرى. هذا لا يعني بأي حال أن العنف في هذه المجتمعات مجرد فرجة بل واقع قائم، وما نقله إلى الشاشة سوى ترجمة لحقيقة مؤداها أن العنف فيها يكتسي قوة أكثر.
والجدير بالذكر أن وسائل الاتصال تأخذ على عاتقها نقل العنف إلى الشاشة، إما في شكل سينمائي وحكائي أو في شكل تفاعلي أو في شكل خبر إعلامي. والملاحظ هو أن لكل نشرة إخبارية أو قصاصة نصيبها من العنف. يتجلى العنف في وسائل وتكنولوجيا الاتصال الحديثة، مثلما الأمر في ألعاب الفيديو والإنترنيت التي تستعرض العنف بكيفية تفاعلية. أما بفضل التأثيرات الخاصة فقد بلغت السينما شأوا بعيدا في إظهار العنف.
إن خاصية وسائل الإعلام والاتصال الحديثة وعلى رأسها الثقافة البصرية هي كونها تعمل على الإظهار Monstration. ذلك ما بدا واضحا مع الأحداث الدراماتيكية لهجمات الحادي عشر من شتنبر، التي حظيت بتغطية إعلامية عز نظيرها. وهنا يطرح السؤال إلى أي حد تقترن الصور بالعنف، وهل ثمة صور عنيفة بحد ذاتها أم لا توجد سوى صور للعنف؟ هل العنف مكون أساسي للصورة وجزء لا يتجزأ منها، خاصة إذا علمنا أن صور تلك الهجمات تبدو صورا عنيفة.
ويرى “دانيال دايان Daniel Dayan ” في كتابه (رعب المشهد: الإرهاب والتليفزيون) (La terreur Spectacle) أن تلك الصور بالرغم من كونها مذهلة ودراماتيكية، ليست عنيفة إلى الحد الذي يمنع من مشاهدتها، فصور الحدث قابلة للمشاهدة Regardables رغم كل شيء. لا تكون الصورة عنيفة من وجهة نظره وإنما تنقل فقط عنف العالم. وهنا وجب التمييز بين الصورة – الأيقونة والصورة – الإشارة، ففي الأولى لا أهمية مخصوصة لرؤية الناظر أو المشاهد، فيما الثانية تتوقف عليها لاستشعار العنف الذي طال ضحايا هذا الاعتداء.
في نظر “دافيد تراند David Trend” ليس العنف مكونا أساسيا لوسائل الإعلام والاتصال عموما وللصور بصفة خاصة، بقدر ما هو استجابة لحاجات المجتمعات المعاصرة للعنف. تقتضي ثقافة الاتصال المعاصرة صور العنف حتى لا نقول الصور العنيفة من أجل استعراضها بكيفية تجعلها قابلة للاستهلاك على نطاق واسع. ما يحدث هو محاولة إضفاء جمال ما على المشاهد والصور المثيرة للعنف حتى تصير مقبولة ومستساغة، بل ومرغوبا فيها.
وفي مقابل هاتين المقاربتين اللتين تعتبران أن العنف ليس خاصية جوهرية للصورة، ثمة مقاربة للفيلسوف الفرنسي “جان لوك نانسي Jean Luc Nancy” ترى أن الصورة عنيفة بحد ذاتها بحكم انتشار ثقافة الترفيه التي تشرط الإنسان المعاصر وتوقعه في أسر عنف الصور. إن العنف معضلة فلسفية، ويعتبر التحدي الأساسي للعقل إلى حد يجعله لاعقلانيا، ومدمرا للحقيقة ولذاتها معا. ينجم العنف عندما تنفلت القوة من عقالها، وعندما لا تحكمها علاقات مضبوطة. من المفروض أن تخضع القوة إلى توازنات وإلى علاقات، أما إذا تجاوزت الحد وأمعنت وأفرطت، انقلبت إلى فوضى، وأدت إلى عنف لا يبقى ولا يذر. صحيح إن العنف لا مندوحة منه ولا مهرب، ومن دونه لا يتقدم التاريخ ولا يتأخر، إنه جزء لا يتجزأ من الممارسة والفعل الإنسانيين، فمهما كان العنف مدانا أو مطلوبا، ومهما كان العنف مشروعا أو غير مشروع، مبررا أو غير مبرر، ثوريا أو غير ثوري، فهو مكون أساسي للتاريخ الإنساني.
ولابد للعنف من الصورة، فهو لا يقوم من دونها، لأنه محتاج إلى الظهور والإظهار، فلا ترى آثاره على الموضوع أو على الذات الممارس عليها سوى بواسطة الصورة التي يتركها. يقول “جان لوك نانسي” : “يتمثل العنف تحديدا فيما يتركه من علامة”[6]. تكمن قوة الصورة في مدى إظهارها الشيء واستدعائه للحضور، ويعتبر العنف في حكم الغائب إذا لم يتوسل بالصورة لإظهاره. ويقول في نفس السياق: “إن الصورة أساسا إظهار”، أي إظهار لعلامة أو أمارة العنف.
هناك مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها في الموضوع، ما نصيب الصورة من الفن، وما قدر الفن في الصورة، وبالتالي ما الذي يجعل الصورة فنية؟ ما الفروق بين أنماط الصورة الإشهارية والدعائية والسياسية من جهة والصورة الفنية من جهة أخرى؟ يمكن الانطلاق من فرضية مؤداها أن الصورة الفنية، أو الصورة في الفن تفوق الأنماط الأخرى للصورة، وتحتوي على فائض قيمة لا نعثر عليه في الأولى، وهو ما يجعلها أكثر أصالة ودواما وقوة وإبداعا. ثمة إذن فائض أو قيمة فنية تفتقر إليه الأنواع الأولى من حيث كونها إما تبلغ رسالة، أو تكرس إيديولوجية، أو تروج منتجا أو سلعة، وتحتوي عليه الصورة الفنية لأنها تتجاوز المألوف والسائد، وتقاوم المبتذل. نجد أنفسنا في الفن أمام صورة خالصة لا تنقل شيئا ولا تروج لشيء، تحمل في ذاتها قيمتها الفنية التي تكمن في قوتها على التعبير بخطوطها وألوانها، وبضيائها وظلالها. وسواء اتفقنا على أن الصورة تحيل إلى الواقع أو لا تحيل إليه، وبضيائها وظلالها. وسواء أقررنا بأنها تمثل أو تجريد، فنحن دوما أمام نمط من الصورة مكتفي بذاته، معبر عن نفسه من خلال مقومه الذاتي ومن خلال الأشكال والألوان والخطوط.
يمكن أن نضيف إلى هذا الفائض الفني خاصية أخرى ويمكن تلخيصها في قابلية الصورة الفنية أن تتكون وتتشكل على نحو لا نهائي حسبما تقتضيه قدرتها على التعبير. وسيلة الصورة الفنية في التعبير هو الرموز الفنية التي تعرف بتعبيراتها لا بفحواها أو مضمونها، من خلال تركيبة لونية ما، أو خطوط وأشكال مقصودة لذاتها، إلى حد يمكن الحديث معه عن لغة تشكيلية، أو لغة بصرية، يتكون عمودها الفقري من:
– العناصر المكونة من سطح الصورة ذاتها ولونها وقيمتها البصرية.
– البنيات المركبة من النقطة والخط والإطار.
ولا يقل التصوير الفوتوغرافي فنية من الفنون البصرية غير الآلية، لأنه يمكن أن يتوسل هو الآخر بالتركيب ليكون تعبيريا. وهناك من يعتبر أن التصوير الفوتوغرافي، إذا ما توفرت فيه معايير محددة، لا يقل تعبيرية عن التصوير الصباغي. منذ أن هجر الفن البصري التمثل، وتحرر من عبء محاكاة الواقع. لم تعد للأشياء الملونة قيمة بقدر ما صارت للألوان ذاتها قوة تعبيرية خاصة بها، ونفس الشيء يقال عن الأشكال. فالمهم هو أن تعاد الأشياء إلى أشكالها الأولية. بحيث أن للأشكال كما للألوان حياة خاصة لا ترتبط فيها بالأشياء، ولا بالموضوعات، ويكفي النظر إلى تيارات الفن الحديث لكي نتبين هذا الاتجاه. ومهما اختلفت منازع الفن الحديث، من المنزع التكعيبي إلى المنزع البدائي، ومن المنزع التجريدي، نكاد لا نعثر على أي اهتمام بالواقع فيما عدا ما يوحي به من أشكال، وفيما يعبر عنه من ألوان.
كما أن الصورة تتخذ في الفن مسارا مختلفا عما هي عليه في صناعة الإشهار، وفي مجال الإعلام والاتصال، وفي ميدان السياسة والدعاية، وتحظى بمعالجة خاصة تجعلها أكثر تعبيرية وإبداعا، ودالة بنفسها لا بغيرها، ومرتكزة على معاييرها الجمالية والفنية.
إن الصورة في الفن الحديث هي اشتغال على المواد، وتطويع لها على نحو يجعلها معبرة بنفسها، تبدو وكأنها تخلصت من الشوائب ومن الزوائد، ومن كل ما من شأنه أن يعلق بها من ابتذال من جراء الاستعمال الإعلامي أو التجاري أو الدعائي. يعمل الفن على إبراز مادية الصورة كما وحجما ومساحة، مثلما يعمل على زيادة قوتها التعبيرية لونا ونورا ووهجا، وأخيرا يعمل على تحويلها إلى أشكال من النقطة إلى الإطراء.
وقد تلونت الصورة في تاريخ الفن الحديث تلوينات حسب تياراته المختلفة وأساليبه المتعددة، وتجددت في كل مرة ومع كل تيار واتجاه على نحو من الأنحاء: اتخذت مع التيار التكعيبي أحجاما، ومع التيار التجريدي أبعادا هندسية، ومع التيار الوحشي مساحات وألوانا. ففي كل مرة يشتغل على الصورة نوع من الاشتغال، يجعلها أكثر تعبيرا بذاتها وبقيمها التشكيلية دونما حاجة إلى حمل خطاب أو تمرير رسالة أو تسويق ماركة أو تكريس إيديولوجية. وعندما نقول إن الصورة الفنية خاضعة إلى نوع من الاشتغال يجعلها أكثر صفاء وأقوى تعبيرا فذلك بفضل انتهاك أو خرق Transgression القواعد البصرية المكرسة من خلال عمل تحويل دائم للأشكال. كل التيارات الفنية البارزة أحدثت هزات عنيفة في مفهوم الصورة: خد التكعيبية مثلا، فمن أجل تحويل الصورة عن محاكاة الواقع، اتخذت كل الوسائل الكفيلة بتحويل الأشياء إلى أحجام بحيث تظهر لا كما هي وإنما كما تبدو في عين الفنان، فضلا عن إبرازها لبعد خفي للواقع لا تتمايز فيه الزوايا، ولا تختلف المنظورات، فهي متساوية لأنها تشغل نفس الحيز، وتوجد على نفس المساحة.
الصورة كأداة اتصال:
قبل أن يمتلك الانسان اللغة، عبر عن أغراضه وحاجاته وكينونته بالرسوم والخطاطات التي حفرها على جدران الكهوف والمغارات التي كانت تأويله قبل آلاف السنين التي نعرفها، وآلاف السنين التي لا نعرفها. فقد عبر من خلالها عن أحاسيسه وخلجاته وما اعتمل في ذهنه ودواخله من أفكار ومشاعر. وبمرور الزمن تطور التعبير بالرسم كما تطور التعبير باللغة، فصار كل منهما قرينا للإنسان الذي عمل دائما على تجديد وعيه بهما، وتوظيفها للاتصال والتواصل النافعين.
وبواسطة اللغة اتصل الإنسان بغيره وحاور نفسه وأفرغ ما في دواخله أو ذهنه تخيلا وتصويرا وايقاعا، وبالرسم والصورة كشف عما أحسه من جمال، وهو يتأمل كونه وأشياءه. وبين الشعر والرسم محطات التقاء لعل أبرزها وأرسخها أن كلا منهما منبع من منابع الحلم الإنساني المستند إلى أرضيات معرفية وفكرية وتقنية مجددة تمنح النص اللغوي أو اللوحة الفنية القيمة الجمالية وفعلها الاتصالي المأمول.
وبالكلمات ينطلق الإنسان المبدع في رحلة لغوية متناغمة، وموحية وقادرة على رسم صور فنية نابضة بالحياة والحركة وبالخطوط والألوان والظلال. يرسم الفنان لوحات لصور الأشياء وهي تلوح أمام ناظريه وتتحرك أو يتخيلها هكذا مبرزا ما فيها من مظاهر الجمال، أو قبح الخير أو الشر المحبة أو الكراهية العدل أو الظلم.
وقد قدم لنا علم اللسانيات، كما لا يحصى من الوسائل والأدوات للتفكير ولتحليل المفاهيم وإعادة صياغة الأشياء صياغة جديدة. وفي عالمنا الحاضر، عالما العولمة وما بعد العولمة، عالم الفضائيات الصاخبة، عالم الهندسة الوراثية التي تحاول أن تستنسخ نوعا جديدا من البشر أو عقلا آخر للإنسان مثلما استطاعت أن تستنسخ الحيوان، وعالم الشركات الكبرى، ورؤوس الأموال التي توظف للإعلان والإشهار والدعاية، والتي بلغت 250 مليار دولار، بما في ذلك محطة البث التلفازي (MTV) التي تبث إعلاناتها ودعاياتها على مستوى العالم، وعلى مدار الساعة. وفي هذا العالم لم يعد هناك شيء جوهري، فكل شيء بات استعراضيا، أو هكذا يراد له أن يكون بعيدا عن الروح والعقل والوعي، حتى الشعر والمسرح والغناء ولم تعد مقولة أن اللغة أداة للتعبير عن الفكر، مقبولة أو فاعلة في عالم بلا حدود ثقافية، أغفلت فيه الجغرافية، ثم تحرك التاريخ داخلها (فصار كل شيء موجودا في كل شيء ([7]) ينتقل عبر وسائل الإعلام الأفكار والمعلومات والأخبار والاتجاهات والسلوكيات…[8] هكذا أضحى الإعلام اليوم يمتلك كل شيء، ومالكو الإعلام ومسيطرون عليه، والمخططون له هم مالكو المال والنفوذ يوجهون اللغة والصورة على وفق ما يريدون تماما مثلما يوجهون السلع التجارية، ويوجهون لها ويتفننون في ابتكار وسائل وأدوات وطرق متعددة للاتصال، والإعلان والإشهار والدعاية من أجل مناورة عقل الإنسان ومشاعره في محاولة لسحب البساطة من تحته.
غير إن في بعض ما يقدمه الإعلام، من صور وأفلام على أنواعها، مما يظن أنه إمتاع وتسلية ما هو إلا إغواء وإغراء، دفع ويدفع ببعض الناس إلى استقبال ما في هذه الصور والأفلام باستسلام واسترخاء، حيث تنقلب قيم الأشياء ليصبح ما يبثه الإعلام من صور نعيما فيه الخلاص، والمتعة والسعادة. إن العين لتسترجع في الصورة سذاجتها حقا، وتسترجع أيضا سرعة تجاربها مع الاندماج بالصورة لحظة المشاهدة في موضوع الرؤية والتصوير، واسترجاع العين سذاجتها هو أول خطوة في طرق التذوق، والتقدير الجمالي للصورة بكل أنواعها التشكيلية والفوتوغرافية والفيلمية والتأثر الذي تلقيه الصورة في نفس المتلقي (يشبه التأثير الذي تحسه النفس البشرية عند رؤيا الله سبحانه على حد تعبير الصوفيين من حيث كونه تأثيرا يستعصي في تأثيره على الإفصاح والإبانة عنه ولا يكفي أن تحركنا الصورة عن طريق الوجود التعويضي لشيء يراد لنا أن ننجذب له، ونغرى به، ونستميل إليه وإن كنا لسنا إليه)[9].
ولكننا نجبر على أن نتحرك في فلكه، وقد تسرب الانفعال في مشاعرنا وتوتراتنا النفسية بل العصبية؛ فالصورة في الإعلام لا يهمها كثيرا المغزى الأخلاقي أو الأدبي أو الإنساني، ولا يفكر صانعوها في إصلاح ذوق أو إمتاع نفس أو (درء مفسدة) على حد تعبير الأصوليين بل إنها عالم خال من القيم وإن كانت مليئة بتشكيلات مبهرة وآسرة، بل إن الإعلام بكل تقنياته الرقمية والإنترنيت أصبح سمة من سمات العصر الحالي والمتحكم الأقوى في العقول والعواطف وسواء اعتمد هذا الإعلام اللغة أم الصورة أم غيرهما في التوجه إلى الناس. لا يفكر أكثره اليوم بأخلاقيات العمل الإعلامي المفترضة، يعني: الصدق واحترام الكرامة الإنسانية والنزاهة والعدالة والمسؤولية[10]، بل إن أغلب وسائل الإعلام تمارس (استراتيجية الإلهاء) المتمثلة في تحويل أفكار الناس عن الأزمات المهمة، والأحداث الكبرى والقيم المثلى التي يمكن أن تبني رأيا عاما سليما ومبدعا. زد على ذلك أن وسائل الإعلام العربية يعتمد أكثرها اعتمادا شبه كامل على المواد الإعلامية القادمة من الغرب بما فيها المسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة[11] والدعايات والإعلانات، وهذه المواد تخاطب مجتمعات غير مجتمعاتنا، وقيما غير قيمنا.
سارة الصاوي

باحثة مغربية، حاصلة على الماجستير في التحرير الصحفي والتنوع الإعلامي، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب.
[1] François Dagognet : Philosophie de l’image Ed Vrin 1986. P 21. Vrin reprise from internet : google livres.
[2] R Debray : Vie et Mort de l’image p 38.
[3] عبد العالي معزوز، فلسفة الصورة “الصورة بين الفن والتواصل”، ص147، 148.
[4] عبد العالي معزوز، فلسفة الصورة “الصورة بين الفن والتواصل”، ص150.
[5] J Baudrillard : Simulacres et simulation Ed Galilée 1981 Paris p 121.
[6] J L Nancy : The ground of the image. Translated By Jeff Fori. Copyright 2005. Ed Fordham Press USA. P. 20.
[7] هانس بيتر مارتين وزميله: فخ العولمة، ص52
[8] عبد الله عبد الخالق: العولمة وتأثيراتها السياسية والاقتصادية، ص2
[9] أدمان، أروين: الفنون والإنسان، ص 102
[10] ينظر: الوز، د. هزوان: الإعلام: أدوار وإمبراطوريات ص 25 – 26.
[11] القصيبي، غازي عبد الرحمان: الغزو لثقافي، ص16.